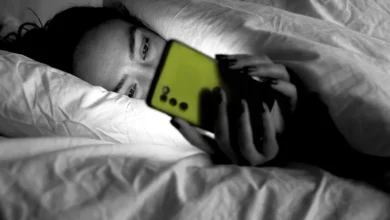ثاقب أحمد
على مدار التاريخ، كان صعود قوى جديدة وسقوط قوى عظمى قائمة بمثابة ديناميكية دائمة تعيد تشكيل النظام الدولي. ولكن، هل تؤدي كل تحولات القوى إلى الحروب؟ أم أن هناك معايير دقيقة تحدد متى يصبح الانفجار العسكري أمرا محتوما؟
هذا السؤال كان محور دراسة تحليلية معمّقة أعدها Woosang Kim وJames D. Morrow حيث قدما نموذجا نظريا مدعوما ببيانات تاريخية لفهم “متى” ولماذا تندلع الحروب نتيجة لتحولات القوى.
يتأسس النموذج على فكرة أن القوة النسبية بين الدول ليست ثابتة بل تتغير بفعل عوامل مثل النمو الاقتصادي والتعبئة العسكرية والقدرة على حشد الحلفاء. وفي خضم هذا التغيير، تمر العلاقات الثنائية بين الدول الكبرى بمرحلة حرجة يتخذ فيها الطرفان قرارات مصيرية: هل ستخوض الدولة الصاعدة الحرب لتغيير الوضع الراهن؟ وهل ستقاوم الدولة الآفلة حفاظا على مكاسبها؟
النقطة المركزية في هذا النموذج هي “النقطة الحرجة” وهي اللحظة التي تدرك فيها الدولة المتراجعة أن تكلفة مقاومة التغيير أصبحت أعلى من ثمن الاستسلام. قبل هذه اللحظة، تكون الحرب ممكنة فقط إذا اعتقد الطرفان أن المنافع المتوقعة من الانتصار تفوق تكاليف القتال.
تشير الدراسة إلى أن احتمالية اندلاع الحرب خلال تحولات القوى تزداد في الحالات التالية: عندما تكون الدولة الصاعدة أكثر ميلا للمخاطرة فتفضل اللجوء إلى الحرب مبكرا لفرض رؤيتها للنظام الدولي وعندما تكون الدولة المتراجعة أكثر ميلا للحذر والمقاومة فتميل إلى خوض حرب وقائية في محاولة أخيرة للحفاظ على وضعها.
كما أن احتمالية الحرب تزداد عندما تقل التكاليف المتوقعة للحرب سواء ماديا أو سياسيا وعندما تكون الدولة الصاعدة غير راضية عن الوضع الراهن وتراه مجحفا.
وأخيرا، يكون الصراع أكثر احتمالا في فترات التقارب النسبي في القوة بين الطرفين حيث يصبح ميزان القوى هشا وغير مستقر.
إقرأ أيضا: من كييف إلى غزة: معركة واحدة تكتب نهاية النفوذ الغربي في العالم؟
على النقيض، يرى الكاتبان أن معدلات نمو القوة بحد ذاتها وكذلك لحظة “التساوي” الفعلي في القوة، لا تشكل عوامل مباشرة في اندلاع الحرب وهو ما يتعارض مع نظريات تقليدية كـ”نظرية انتقال القوة” التي تعتبر نقطة التساوي هي الأكثر خطورة.
تلفت الدراسة إلى خطأ شائع في احتساب موازين القوى وهو تجاهل تأثير الحلفاء. فالقوة الفعلية للدول لا تنبع فقط من قدراتها الذاتية بل تتعزز أيضا بمدى قدرتها على استقطاب دعم الحلفاء.
لهذا السبب، اعتمد الباحثان على قياسات “القوة المعدّلة” التي تشمل الدعم المحتمل من الأطراف الثالثة مما أدى إلى نتائج أكثر دقة عند اختبار نموذجهم إحصائيا عبر العلاقات الثنائية بين القوى الكبرى من 1816 حتى 1975.
تشير الدراسة إلى أن الحروب الكبرى لا تنشأ عادة نتيجة تحول مباشر في القوة بين دولتين بل تبدأ كحروب محدودة ثم تتوسع بفعل تدخلات أطراف أخرى ترتبط بمصالح متشابكة. الحرب العالمية الأولى التي بدأت بنزاع بين النمسا وصربيا، مثال صارخ على ذلك.
لهذا، فإن تحولات القوى لا تخلق الحروب بذاتها لكنها “توفر الشرارة” التي قد تشعل صراعا أوسع إذا توافرت البيئة المناسبة من تحالفات ومصالح متشابكة.
يقودنا نموذج Kim وMorrow إلى مراجعة جذرية لفهمنا لأسباب الحروب الكبرى. فليست التحولات في القوة وحدها هي من يحدد المصير بل كيفية تفاعل الدول مع تلك التحولات وفق حسابات المخاطرة والتكاليف والتحالفات.
وعليه، فإن استشراف الحروب المستقبلية يتطلب تحليلا دقيقا لميول الدول نحو المخاطرة والرضا عن الوضع الراهن وليس فقط مراقبة مؤشرات القوة الصلبة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري ل UrKish News